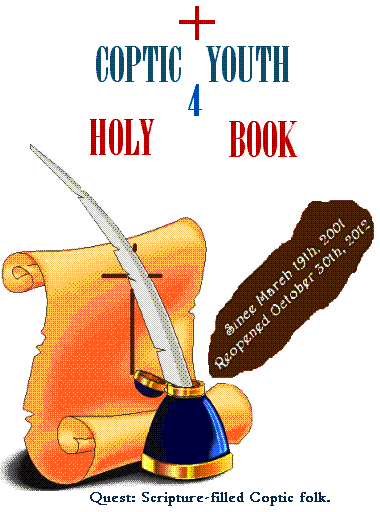 الطبيعة الواحدة التي للمسيح!!! الطبيعة الواحدة التي للرب المتجسِّد الإنسان يسوع المسيح الإله رابط لصفحة اونلاين للكتاب على موقع "كوبتك يوث فور هولي بووك" طبيعة المسيح الواحدة هي الهديّة التي
قَـدَّمها المسيح للبشريّة، وهذا المقال المتواضع أهديه بدوري لإخوتي القبطيين
الأرثوذكس الذين ضاق بهم حال كنيستهم فطلبوا الانطلاق للكنائس اليونانيّة، متشكِّكين
أو متبرِّمين بموروثهم الذي تاجه هو التمسك بالقول بطبيعة المسيح الواحدة..
وأهديه بأكثر حرارة لإخوتي من الكنائس
الأرثوذكسيّة الشرقيّة المخلصين لأمل تمام وحدة الكنائس في المسيح، وإن
كانت تأخذهم حميّة الزهو بالشعارات "الأرثوذكسيّة" الجذَّابة.. إليهم جميعاً أهدي مقالاً متواضعاً عن "الطبيعة
الواحدة التي ليسوع الإله" التي فيها وبها يُوَحِّد جميع مختاريه حتى
يكونوا واحداً فيه مع الآب بالروح القدس كما أنه والآب وروحهما القدوس واحد.. لا أكاد أصدِّق أنني عدت بعد كل هذا للكتابة
في هذا الموضوع، الذي يسمونه الصراع الكريستولوجي.. وأما هذا الذي عدتُ بعده،
فسأفصّله في مًلحَق "حديث ذكريات".. وأنبّه أنني لن
أتكلّم بالأساس عن مجمع ولا عن تاريخ ولا عن أشخاص، ولا عن شروح أشخاص بكل ما بها
من احتمالات معانٍ وإشكالات تعابير وفشل في الفهم والتفاهم، فخارج الغرض الدقيق
هنا لوم أولئك الذين رفضوا قولاً صحيحاً أو مؤاخذة هؤلاء الذين فشلوا في جودة شرحه؛
وإنما غاية المقال هي فحص صياغة مجردة مظلومة من أصحابها قبل خصومها، أتبنّى صحتها
وأظهر فضلها وأكتب لإظهار صحتها وجودتها، وهي صياغة "طبيعة المسيح
الواحدة"!! إنّ مراجعة تلك الجدليّة كلها مراجعةً غير
مسبوقة قطّ سيكون لها تفصيلها في مواضعها،[i] هنا، وهنا، وهنا،
وهنا،
وغيرها، وإنّما
القصد هنا يقتصر على ما انتهت إليه الجدليّة من تعبيرين قاما كخصمين وحُكِم بحرمان
أحدهما في أكبر مجامع التاريخ، وهاهنا بعون الرب سأفصِّل حيثيّات الحكم على ذلك
الحكم بالخطأ!! فأما
إن ساقني الحديث للمساس بأطراف أحداث التاريخ والمجامع، فسيكون ذلك في حدود
الهوامش والملاحق للموضوع الذي لن أفارق موضوعيّته قبل مقاربتها من جميع الاتجاهات
الموضوعية الممكنة.. ولا أنسى أن أزيل الملل المُتَوقَّع لدى البعض
الذين محصوا تاريخ الموضوع حتى أيقنوا أنه لا جديد يُقال فيه؛ فلازلت عند طبعي
أنني لا اكَرّر ولا أتكلم بما ليس لديّ جديد نافع فيه.. وَعْد! واستسماح أخير، فإن التسميات لا أتبع فيها
التعريب الرائج ذي الحروف الثقيلة بل أصوغ الاسم بحسب نطقه الأصليّ يونانيّاً كان
أم لاتينيّا، هذه عادة أرجو ألا تثقل على القارئ وأن يعتادها منِّي برضى..اكثر
الكلمات تكراراً من هذا النوع ستكون "خلقيدونية" التي تصير خالكيدونا J جملتان نحن في كل القصة أمام جملَتَيْن:- ·
شخص المسيح يقوم في طبيعة
واحدة من طبيعتين بدون اختلاط ·
شخص المسيح يقوم في طبيعتين
متحدتين بدون اختلاط مقطعان وبمزيد من تقريب المجهر
على موضع الخلاف، نُركِّز النظر لهذين المقطعين:- ·
طبيعة واحدة من طبيعتين ·
طبيعتين متحدتين الملاحظة الرئيسة هي أن
الصياغة الثانية تقود للأولى بالضرورة.. فنتاج اتحاد طبيعتين هو
طبيعة واحدة، وإلا فكيف اتحدا دون أن
يصنع اتحادهما طبيعة واحدة؟ أي نوع من الاتحاد هذا
بين عناصر لا تكون نتيجته هو كيان واحد من ذات النوع؟ إنه اتحاد مجازيّ أو اتحاد
ناقص على وجه ما من النقص، وليس هكذا نؤمن باتحاد طبيعتَي الرب.. إذاً فالقائل بالجملة
الأولى يشمل الثانية، ضمناً، معه، والقائل بالجملة الثانية
يصل بحتميّة منطق قوله إلى الجملة الأولى.. أين الخطأ الخطأ إذاً ليس في
الإقرار بأي من الجملتين، ولكنه رفض أحداهما! والأكثر خطئاً في الرفض
هو من يرفض الجملة الأولى، لأنها أشمل وتتضمن الجملة الثانية.. وأما من يرفض الجملة
الثانية، فليس بالضرورة يكون رفضه خطئاً.. إذ أن رفضه قد يكون
مبرراً لو كان واعياً لمعنى جملته الأولى، وبالتالي قابلاً للثانية كجز من معنى
الأولى، وإنما سبب رفضه للثانية هو رفض إقرار الجزء على أنه كلّ.. الشيطان لا يختبئ في
التفاصيل هذه المرة، وإنما في التعمية عن الكلمة المحوريّة في القصة كلها،
والتي هي: كلمة "اتحاد" وليست مصادفة أن الشيطان
يُعمي عن كلمة "اتحاد" تحديداً، وهو الذي سقط بفكر الانقسام أصلاً
والانفصال عن الرب الذي فيه وحده، في وحدانية الثالوث، تكون كل كنيسة البشر واحداً! وأما وقد نجح هذا
الإبليس في التعمية عن الأصل، وامتلأت الدنيا تفاصيل خلاف وصراع أحمق، فقد وفروا
لشيطان مساكن إضافية من نفسهم.. وبإزالة تعمية الشيطان
يسهل إزالة عشوائيات صراع الألف السنة وبضع مئات، ولا يجد الشيطان سكناً بيننا..
بالنظر في كلمة اتحاد وإيفائها حقها من الفهم المنطقيّ والروحيّ تستنير عيون الذهن
والضمائر، ومن كانت عينه منيرة فإيمانه كله يكون نيِّراً.. فما معنى اتحاد؟ ولماذا يُلزِم قبول اتحاد
الطبيعتين في المسيح بقبول أنهما صارتا طبيعة واحدة؟ إن طبيعة "الطبيعة" تجعل نتاج اتحاد
الطبائع هو طبيعة جامعة.. ما هي الطبيعة؟ إنها
مجموع خصائص وصفات صاحبها التي تميّزه عن غيره ممن لا يحوز نفس الطبيعة.. فعندما يُقال الطبيعة
البشريّة، فهي مجموع الخصائص التي يكون كل من يمتكلها مُجمَّعة ينتمى للبشر، ومن
يفقدها يكون غريباً عن الصنف.. وما هي طبيعة فلان
تعييناً من البشر؟ إنها الخصائص التي يحوزها خصيصاً فوق عموم الخصائص التي للجنس
كله، فتميزه بين جنسه عن غيره من الأفراد.. وهكذا... فماذا عندما تتحد
طبيعتان؟ تتحد ببساطة مجموع
خصائصهما.. ومجموع الخصائص مع مجموع
خصائص أُخرى يُكَوِّن مجموعة اشمل من الخصائص أي يُكَوِّن
طبيعة أشمل.. هذه هي النظرة الخارجية البسيطة
للمعنى، ولا يُغيّبها على بداهة
منطقها إلا الاندفاع للفحص الداخليّ قبل توثيق التسمية الصحيحة خارجيّاً.. وأما الفحص الداخلي
فيحمل هَمّ سؤال آخر هو طبيعة العلاقات بين الخصائص، وسؤاله الرئيس في موضوعنا هو: هل هذا الاتحاد يلتهم
خاصيّة لحساب الأُخرى؟ هذا القلق وانتظار هذا
السؤال لإجابة، لا يغيّر حقيقة أن الاتحاد أنتج طبيعة واحدة.. ويكفي لإزالة قلق هذا السؤال، القول إن
الاتحاد كان بدون تغيير في داخل كل طبيعة - اتحاد يحفظ خصائصها.. يكفي جداً ولا يجعل هناك
أدنى حاجة للجَوْر على حقيقة أن الاتحاد جعل الطبيعة المتحدة واحدة.. ولو كان الالتزام بقول
"طبيعتين" ملزماً، حتى لا يُفهَم أن صفة التهمت الأُخرى، للّزّم أن
نعدِّد الطبائع، أي طبائع، بعدد الصفات الثابتة المستقرة فيها.. فماذا مثلاً لو فحصنا
طبيعة الإنسان الذي يبقى الجسد فيه جسداً والروح روحاً؟ هل يحرم القم بكلمة
"الطبيعة الإنسانيّة"؟ ويلزم الالتزام بالقول/
دون
تعدِّي أو زيادة، بـ"الطبيعتين المتحدتين في الإنسان"؟ بل هناك صفات متعددة في
الإنسان الواحد في إطار اتحاد الجسد زالروح: له لون وحجم ونزعات عصبية واتجاه
فكريّ وأهواء و و و وهذه تجتمع معاً في وحدة
عجيبة ملموسة ولكن يمكن تمييز كل منها ببساطة فهل يلزم القول
"مجموعة الطبائع الإنسانيّة"؟ إن اتحاد الطبائع ينتج
طبيعة.. طبيعة المسيح هي الأَوْلَى بالوصف بـ "الطبيعة الواحدة" أَوْلَى اتحادات الطبائع
بإثبات الطبيعة الواحدة لها هو اتحاد طبيعتَي المسيح فإن كانت الطبائع
القابلة للافتراق والتي تفترق حتماً (مثالنا و الطبيعة الإنسانيّة المكونة من
اتحاد طبيعة روحيّة وأُخرى جسديّة) إن كانت هذه تفترق ولكنيقال لها طبيعة واحدة
حال اتحادها فكم بالأولى المسيح الذي
لا يفارق ناسوته لاهوته لحظة واحدة بإقرار الجميع؟ كيف نظر المسيح لطبيعة
نفسه؟ إنه سؤال خطير! فلا يعرف الإنسان إلا
روح الإنسان الذي فيه.. فكم بالأولى الرب خالق الإنسان؟
كم بالأولى الروح القدس الواحد مع المسيح؟ فهل نظر المسيح قطّ إلى
نفسه على أنه طبيعتين لا يجوز مع اتحادهما النظر لهما على أنهما، فيه، طبيعة واحدة
شاملة؟ كيف نعرف نظرة الرب
لنفسه؟ من كلامه: كان لكل كلامه
ذات الطبيعة : ذات الغاية وذات الحكمة وذات التأثير.. من أعماله: وكل أعماله
حملت طبيعة واحدة في سلطانها ورسالتها.. إن الرب لم يُشِر قط ولا
بَدَر منه ما يوحي بأنه يعي أن اتحاد الطبائع فيه يقف دون اعتبارهما طبع واحد.. بل حتى هذا التقسيم الذي
تبناه البابا ديوسكورس نفسه أراه متجاوزاً الدقة.. فعندما يقول أراه يمشي
على البحر كإله وينام كإنسان، أقول أنا بالمقابل: هو يمشي على البحر كإنسان له قوة
الإله، فالإله، حال كونه إلهاً فقط، لا يمشي.. وينام كإنسان تظهر فيه
يقظة الإله.. إن الإصرار على التوقّف
دون القول بطبيعة واحدة نتاج الطبيعتين المتحدتين، ذلك الإصرار على نفي واحديّة
الطبيعة في المسيح رغم القول باتحادهما، يحمل ضمناً لزوم ظهور وعي المسيح بهذه
الإثنينيّة على مستوى الطبيعة دون الواحديّة فيه وهذا ما لم يظهر قطّ.. بل دائماً كان الرب يسلك
بتلقائية دون الالتفات لهذه الإشكاليّة المصطنعة.. وهي التلقائية التي
تستدعي تلقائية المؤمنين بدورهم في الكلام عن المسيح الواحد أنه شخص واحد وطبيعة
واحدة.. إن واحديّة الشخص
وإثنينيّة الطبيعتين المتحدتين دون واحديّة هو أمر غريب عن المسيح! ومصطنع.. ومن يشعر بالألفة معه
فهو لم يدخل المجمع ومعه الكتاب المقدس؛ بل يفتح الكتاب المقدس، ويقف على رأسه كل المجتمعين في المجمع.. إنه
يسلك بالعكس! وليس هكذا يُقرَأ
الكتاب ومكتوب كيف أفهم إن لم
يرشدني واحد ولكن لم يُكتَب
"كيف لا أفهم المكتوب قبل مئات السنين حتى يأتي من يتعاركون على شرح المكتوب" طاقَتَا
عمل اقترح البعض هذه الصياغة
لإبرازها في الحوار الكريستولوجيّ وهي موفَّقة جداً، وتصل
بنا لنفس الغرض.. فالطاقة تُجمَع على
الطاقة لتنتج محصلة طاقة واحدة دون تغيير ودون اختلاط
ودون دون ولكن ألا تًسمَّى
المحصِّلة للطاقات طاقة؟ هنا ينزعون للكلام على
أن الوحدة هي على مستوى الشخص.. صحيح.. ولكن ليس فقط! فالشخص الواحد الذي يحمل
طاقَتّي عمل، ويعمل بهما.. حتى لو افترضنا معهما أن
الطاقتين تبقيان متحدتين دون عملهما كمحصلة طاقة واحدة داخله، وهو ما اظهرت الفقرة
السابقة عدم صحته، ولكن حتى لو افتُرِض هذا مجاراةً، فما هو حال هذين الطاقتين حال
ظهور العمل القائم عليهما؟ لو بقيت الطاقتان عند
مخرجهما ليسا بقوة طاقة واحدة، لبقيت الأعمال القائمة عليهما غير متحدة هي الأُخرى.. ولكانت النتيجة أعمال
تامة التمييز، نستطيع أن نقسمهما بشكل قاطع إلى ناحيتين: واحدة للإله والأُخرى
للإنسان.. وهنا، فأين يقع الصليب؟ وأين تُصَنَّف القيامة؟ إن اتحاد الطبيعتين،
والطاقتين، يبقى حاملاً أصل التمييز، ولكنه لا يقصر عن الاتحاد الحقيقيّ الذي تكون
نتيجته أن الاثنين يصيران واحداً، وأن الطبيعتَيْن يصيران معاً طبيعة واحدة تحتفظ
بأصل التمييز داخلها، وأن الطاقتين تصيران بالمثل.. إن التوقّف عند القول "باتحاد
الطبيعتين" والقصور عن القول "إن اتحادهما صيّرهما طبيعة واحدة" هو
انقلاب ضمنيّ على رأس الكلام، وقطعه دون حسن ختامه وإثبات حقيقته، وإن لم يقصد
صاحبه ذلك.. إن التوقّف دون الإقرار "بالطبيعة
الواحدة" يصل منطقيّاً بالتفكير إلى إثنينيّة رآها نسطور في مجمع خالكيدونا
فجاز له معها الثناء عليه رغم كل الحروم التي سقطت على اسمه في هذا المجمع
وتوابعه.. خروج من المقطع الضيق لرحب الجملة الشخص الواحد له طبيعة واحدة[ii] إلى الآن انطلق
الفحص من كلمة "اتحاد الطبيعتين"، المقطع الأضيق المهمل في القضيّة،
ولكن بتوسيع مساحة البحث، ومقاربته من خلال سياق الجملة الخالكيدونيّة كاملةً: "طبيعتان
متحدتان في شخص (أقنوم) واحد" فإن المقاربة هذه
تصل لنفس النتيجة: فالشخص (الأقنوم)
الواحد يُلزم بالضرورة بالقول بالطبيعة الواحدة له! إن تأمّل ارتباط
الشخص بطبيعته يحتِّم وحدة طبيعته فالشخص وعي واحد وإرادة واحدة وتحكّمه في
طبيعته لو كان شخصاً صحيحاً بلا مرض، هو تحكّم مباشر يجعل التمييز بين أي صفات
وخصائص له هو تمييز في وحدة تامة قائمة على وحدة شخصه قد يملك الإنسان
أملاكاً ماديّة تبقى متحدة وحدة جزئية غير تامة، وقد تبقى حتى منفصلة لا تتَّجِد
إلا عند انصباب أرباحها في جيوبه ولكن علاقته
بطبيعته الشخصية لا تعاني من هكذا تميز هناك تميز ولكن
لا يعوّق أبداً القول بالواحديّة مثلاً إنسان له
صفتان صاحب عمل وأب يعمل ابنه عنده
في العمل وهو نسان نزيه
وجاد في عمله مثلما هو أب مخلص ومحب لابنه هو في البيت أب
وفي العمل رئيس يعامل مرؤوسيه معاملة واحدة بقانون واحد فهل هذ
الإثنينيّة الواضحة التميزّ إذ اتحدتا في شخص واحد تعسر على التسمية بصفة واحدة؟ كلا - بل هو "أب-رئيس"،
أبوته مترئسة في البيت، ورئاسته أبويّة في العمل فهو في البيت أب،
والأب يعلِّم ابنه، ويعلّمه من واقع خبرته هو، وخبرته هي في عمله الذي يرأسه، فهل
يملك واحد ان يتصوَّر ان من متطلبات نزاته كرئيس ألا يعلِّم ابنه ما ينفعه في
عمله؟ ثم هو العمل
رئيس، فهل لو وقع ابنه في ورطة في عمله، ألا يتدخَّل لحمايته بعاطفة الأبوّة؟
يتحمَّل الخسارة من جيبه فهو صاحب العمل والمال، وليس في ذلك مخالفة، والانحياز
هنا ليس خروجاً عن أي أصول وظيفته بل مراعاةً لأصول أبوته ومهما تغيّر
المثل لتصعيب الأمر، فسيبقى الشاهد واحد: أن تميز الصفات في واحديّة الشخص ينتج
بالضرورة صفة واحدة مجمعة لاجتماع هذه الصفات التمييز لا ينكر
الاتحاد والاتحاد يلزم بالقول بالواحديّة التمييز قائم
حقاً لم أنكر ولا مصلحة لي أصلاً في إنكاره لأنني أتكلم عن
صفة فريدة من اجتماع صفتين ولكن التمييز هذا
لا يمنع القول بوحدانية الصفة للشخص الواحد مع القول بإثنينيّتها في ذات الوقت على
مستوى التفصيل المشكلة كما
بدأتُ من بداية البداية هي في إنكار الجملة الأولى وليس في قبول الثانية طالما لم
تَجُر على الأولى ويستدعي المعنى
الثابت في هذا الفصل نظرة على حجة طالما كرّرَتها الكتب القبطيّة وندر ما خلا كتاب
في زمن الجدل عن الموضوع منها.. ويمكن سياقة
الحجة هكذا: "من تقولون في العذراء أم من هي وكيف تدعونها "والدة
الإله"؟ أن قلتم أنها والدة اللاهوت فقد جدفتم فالإله لا يُولَد من امرأة،
وإن قلتم إنها والدة الناسوت فقط فقد أنكرتم الإيمان بكونها والدة الإله، وإن قلتم
إنها والدة إنسان و إله فقد جعلتموها أماً لاثنين وهذا باطل، فلا يبقى لتسميتها
"والدة الإله" إلا الإقرار أنها والدة الإله من حيث أنه اتحد بالناسوت
المولود منها" الحجة على
سذاجتها وتكرار مقطعها الأول جزئيّاً في الثالث دون لزوم، فهي لم تسعف ولم تخدم
الحوار بل عطّلته.. فالخالكيدونيون يقولون بكل وضوح وقوة أن المسيح شخص أقنوم
واحد، والحجة مبنية على افتراض أنهم يتكلمون عن شخصين.. فما مغزى تكرار هذه
الحجة بهذا الإصرار؟ الإجابة أنه قد صعب على أصحابها أن يقبلوا فكرة
طبيعتين لا يرقيا لمرتبة طبيعة واحدة في شخص واحد، وطالما بقيت الطبيعتان طبيعتين
فقد بقي الشخص شخصين والأقنوم أقنومين.. ولذلك فكلما انطلقوا لمناقشة القول
بطبيعتين متحدتين دون أن تصيران طبيعة واحدة فقد انزلقوا لافتراض أن خصومهم يفهمون
الأمر على أن الشخص شخصان (او الاقنوم أقنومان) لا يثنيهم عن ذلك تأكيد أولئك
بوحدة الشخص (أو الأقنوم)! أخذنا الصراع بعيداً عن الكتاب ولغته، وحصرنا
في مصطلحات ومختصمات.. واضطررت لمجاراة القول والأقوال، وصرت للمجمعيين مجمعيّاً
لأصل للكتاب المقدس بهم راضين.. والكتاب يقول ما يجعل اطمئنان كل المخلصين
لكلمة "البيعة الواحدة" تاماً مستقرّاً.. الكتاب يقول: الكلمة صار جسداً يلزمني هنا التمعن اللغويّ وعدم الاكتراث بأي
إثقال على أي قارئ فضبط المعنى يستحق التعب.. الصيرورة هي الصيرورة أي التحوّل.. حقاً هناك
لغات تتداخل فيها الصيرورة مع الكينونة الثابتة، ولكن ليست اللغة اليونانية من هذه
اللغات.. فكيف يُقال أن الكلمة صار جسداً؟ هل تغيرت
الطبيعة الإلهيّة؟ إن تعيين دلالة الكلمات هنا لازمة.. ومعنا فقط ثلاث كلمات:- + الكلمة + صار + جسداً طرفيّ المكتوب: "الكلمة"، و
"جسد" متسعتا المعنى.. الكلمة تدل على أقنوم وليس مجرد طبيعة.. وبالمثل
فكلمة "جسد" (ساركس) يصحّ أن تفيد معنى الشخص الإنسان الحيّ، وليس مجرد
الطبيعة الجسديّة فيه [iii]..
ولكن ذات هذه الكلمات تحمل معنى الطبيعة!
ولذلك ولتعيين قصد الأقنومية احتاج الشارح من وقت لآخر أن يضيفوا صفة
"الذاتيّ" فيقول الكلمة الذاتيّ.. مع أن كلمة "الكلمة"
بمفردها غنيّة تشير للشخص وتشير لطبيعته المعنويّة أنه الجكمة والمنطق.. وبالمثل
فكلمة "الجسد" تشير للإنسان ولكن بتخصيص طبيعته اللحميّة الحيّة
"ساركس".. الإنجيليّ هنا يتكلم عن "شخص"
المسيح مبرزاً إياه من خلال طبيعته أنه منذ الازل هو الكلمة وأنه في ملء الزمان
صار جسداً! وكان يمكن للإنجيليّ أن يقول "الإله صار
إنساناً"، وهذا صحيح، ولكنه قال "الكلمة صار جسداً".. إن وعي الإنجيليّ للمعنى يشمل الأقنوم بطبيعته
بكل وضوح.. ولو كان "تعبير" الطبيعة الواحدة
بحسب معناه المقصود والمشروح حتى الآن في كل الفصول ومن كل المداخِل، لو كان هذا
التعبير، معنىً أو حتّى نصَّاً، مرفوضاً عند الإنجيليّ لاحترس جداً ألا يتكلم بهذه
الألفاظ البالغة البساطة والقوة.. فكيف يتغيّر الإله كشخص ولا يعود إلها -
حاشاً؟ أم كيف تتغير طبيعته الإلهيّة بحيث يبقى إلهاً بغير طبيعة إلهيّة – حاشا؟ يلزم
الآن فحص كلمة "صار" لضبط المعنى.. ليست كل صيرورة تحمل معها ضياع حالها الأول
ولا حتى تغيّر أعراضه.. لا على مستوى صيرورة الشخص ولا مستوى صيرورة طبيعته.. والأمثلة
كثيرة وقويّة: الابن قد يصير طبيباً ويبقى ابناً،،، الجسم المعتم قد يستنير
ويصير منيراً ويبقى جسماً بحالته الماديّة ويبقى النور نوراً وإن انعكس من ذلك
الجسم.. أو: الملاك يصير ظاهراً ويبقى روحاً.. في كل هذه الأمثلة صيرورة في الطبيعة لا يمكن
إنكارها.. إن الطبيعة الأولى باتحادها بالثانية صارت طبيعة جامعة دون تحوّل في أصل
الطبائع.. فما الذي يخيف الإنجيليّ من قوله:
"الكلمة صار جسداً"؟ وما الذي يخيفنا نحن حتى لا نقول مثله ومعه:
"طبيعة المسيح الواحدة الفريدة؟" لا الإنجيليّ خاف ولا ينبغي لنا نحن أن
نخاف.. فالاتحاد صنع واحديّة جامعة! ولا أبسط.. الكلمة صار جسداً! ورغم أن المدافعين عن القول بـ "الطبيعة
الواحدة" لم يلتفتوا بما فيه الكفاية لهذا القول الإنجيليّ، لعله خوفاً من
اتهامهم بالقول بتحوّل الطبيعة الإلهيّة لما في التعبير الإنجيليّ من قوة ساطعة
على تمام الوحدة، رغم عدم الالتفات الكافي لفريق الطبيعة الواحدة، فإن خصومها
التفتوا وارتبكوا بما يدل على دلالة المكتوب في حسم الأمر.. وفي كتاب ثيودوريت
أسقف صور عن التجسّد ما يُظهِر اعترافهم بإشكالية قصورهم عن القول بالطبيعة
الواحدة أمام هذا النصّ الإنجيليّ.. لقد حوَّل الكاتب البارع القضية إلى إنكار
التحوّل الذي لا نقول به ولا نفهم النص عليه، ثم حاول تجزئة معنى الاتحاد بالإحالة
لشواهد أُخرى ولكنّه لم يجب السؤال: وهل هذه الوحدة تجعل الطبيعتين طبيعة واحدة أم
لا ولماذا؟ [iv] الكلمة صار جسداً يا أيها الجميع المؤمنون
بالإنجيل.. الكلمة صار جسداً، فكيف تفهمونها؟ لا اقصد إرادتان في
المسيح تبعاً للطبيعتين، ولا إرادة للابن غير إرادة الآب حسب التفسير الخاطئ لقول
الرب "لتكن لا ارادتي بل إرادتك" ( لو
22: 42).. أقصد هنالك إرادة الرب في وحدانيّتها، وإرادة
إبليس الحيّة القديمة.. ومن المفارقات التي يظهر أنها صدفة وفي
حقيقتها فهي بترتيب وتحذير من توافيق السماء، من المفارقات أنّ الحية وقد بدأت
تزحف، انتبه هركيوليز متأخراً وحاول توحيد الكنيسة بشعار "مونوثليت" أي
الإرادة الواحدة، وما كان أحوج الكنيسة وقتها للإرادة الواحدة.. ولكن الأوان قد
فات، فمن ناحية أُثبِتَت في الكنيسة خصومات تحلّت بشعارات إيمانية لم يفهمها اكثر
المتشددين لها، ومن ناحية خرجت الحيّة من جحرها لتلدغ، وعبثاً بينهما حاول الملك
بالحيلة ثم بالقوة توحيد ما كان ينبغي له أن يحافظ على وحدته بالمحبة والاقتناع.. لقد اخترع سرجيوس الأول الباتريارك المسكونيّ للملك
هركيوليز بناءً على طلب الأخير صياغة مُلفَّقة على أمل إرضاء الفريقين، وهذا ما
أتى به: "طبيعتان وإرادة واحدة"،،، ورفض الجميع، واضطهد الملك الجميع، وصار من
هنا معترف ومن هنا معترف وما أشهر القديس مكسيموس المعترف الذي تمزَّق لحمه
لمقاومته لهذه الرسالة الجديدة، وأنبا صموئيل المعترف الذي مزّقها هي نفسها
وفقد عينه، فعند "المؤمنين" لا تجوز تجزئة الإيمان ولا المساومة عليه، ويفدونه
بعيونهم ولحومهم، وعند الملوك لا تسامح ولا هوادة مع الانقسام لأي سبب ويفدون
ملكهم بعيون ولحوم الناس.. ولكن لماذا؟ وما الربح؟ فلا اتفاق في الإيمان ولا بقاء
للملك! والآن في تلك المرحلة اليائسة تجدد الصراع
وشعاره: إرادة أم أرادتان؟ وللأسف انتهت النتيجة إلى بقاء إرادات الكنائس متصارعة،
وانتصرت إرادة الحية القديمة، والتهمت ما التهمته من جسم الكنيسة وأظلمت ما أظلمته
من عيونها.. وبكل حقّ كان مع الفريقين الحقّ في رفض
الصياغة المُلَفَّقة.. فالقول بطبيعة يتبعه بالضرورة القول بإرادة، وتتفق الإرادات
مع الطبائع في الجنس والعدد والاتحاد والتميز.. فالقائل بطبيعتين متحدتين يلزمه أن يقول
بإرادتين متحدتين.. والقائل بطبيعة واحدة من طبيعتين يلزمه القول
بإرادة واحدة من إرادتين متحدتين.. والقائلون جميعاً من الفريقين أن الاتحاد بغير
اختلا ولا امتزاج ولا تغيير أحسنوا عندما قالوا المثل على اتحاد الإرادتين.. فكان منطقيّاً ومحترماً أن يرفض الجميع
الصياغة الجديدة.. ولكن كان حريّاً بهم أن يكملوا جميلهم بالبحث عن صياغة أُخرى
ليست في تنظير الإيمان بل في إعماله قبل أن يُلتَهّموا جميعاً.. ولكنهم لم يفعلوا،
ولولا أن الرب أبقى لنا جميعاً بقيّة ما كنّا اليوم نراجع ما وصل بالسابقين إلى
هذا الحال الذي أورثونا إياه.. نعم فلقد نجت بقيّة الكنيسة من لدغ الحيّة بفضل إرادة
الرب الواحدة النافذة الغالبة.. نعم ثم نعم، فإرادة الرب واحدة قبل التجسد
وواحدة بعد التجسد.. واحدة في الثالوث وواحدة في الابن المتجسد، وليس أسخف من
افتراض إرادة للابن غير إرادة الآب إلا افتراض إرادة إنسانية للابن لا يقال عنها
مع إرادته الإلهيّة أنهما إرادة واحدة.. ونفسِّر: "لتكن لا إرادتي
بل إرادتك" (لو22: 42).. ظاهر الكلام هنا أن هناك إرادتين متعارضتين..
إرادة الابن بأن ينجو من الصليب، وإرادة الآب أن يُصلَب ليتمِّم مسرّته بفداء
البشر.. ويذهب البعض لأبعد من ذلك فيفهمون أن تعارض الإرادة هو في داخل الابن بين
إرادة ناسوته وإرادة لاهوته.. والحقيقة الكتابيّة الظاهرة، المتَّفِقة مع
الحقيقة الثيولوجيّة اللائقة، أن الآب
والابن متفقان.. يلزم هنا الالتفات بأوفر تركيز،،، التعارض هو في الجدث وليس في إرادة الآب مع
الابن.. الحدث المهول نفسه يحمل التعارض الذي سبَّبَته الخطية من الأصل عندما
أفسدت التآلف الذي خُلِق فيه الإنسان.. التعارض هو بين كُرْه الرب الإله للخطيّة
واللعنة، وبين محبته للبشر.. هذا الكُرْه وأمامه هذه المحبة في تعارضهما
يشترك فيه الآب والابن جميعاً في وحدانيتهما، وإلا فكيف هما واحد وحدانية فوق
النطق، وكيف أن الابن هو ذاته حكمة الآب وقوَّته؟ وهذه هي الأدلّة الكتابيّة القاطعة أن
إرادة الآب تكره صلب المسبح في ذاته، وإنما تحبه وتريده فقط كوسيلة وحيدة لفداء
البشر وإعلان حبه الأعظم من كل شئ:-. "تعييرات معيريك وقعت عليّ" (مز69:9،
رو15: 3).. فهذا هو صوت المسيح يتكلّم به المرتِّل
نبويّاً ويستشهد به الرسول ليثبت أن الرب تلقّى التعييرات الواقعة في أصلها على
الآب.. ويكفي قولهم في التعيير: "قد اتَّكَل على الإله فينقذه الآن إن
أراده لأنه قال أنا ابن الإله" (مت27: 43).. يكفي هذا لوقوع أبشع التعيير على الآب الذي لم
يكن غائباً قطّ عن مشهد الصليب.. هكذا كان تعيير الصليب مُوجَّه للآب قبل أن
يقع على الابن، واتهاماً له بالعجز والتنكّر لابنه، وحيده، ابن محبته.. وأيضاً: "يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون
ماذا يفعلون" (لو23:34).. وماذا تكون هذه الصرخة إلا صرخة شفاعة تحول
بين غضب الآب على صالبي ابنه وبينهم حتى يتمّ الصليب، وماذا تكون الأولى إلا صوت
الآب معلناً أن التعيير يقع عليه هو؟ فكيف نستبعد من إرادة الآب غضبه
على صلب ابن محبته البارّ؟ إلا أن يكون خضوعاً لتفسير فاشل مهما طال زمن تكراره
على المنابر.. ثم هذه بالمقابل هي الأدلة الكتابيّة على
محبة المسيح للصليب وقبول إرادته له:- "أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن
ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصّته الذين في
العالم أحبَّهم إلى المنتهى..." (يو31: 1).. "ليس لواحد حب أعظم من هذا أن يضع الواحد
نفسه لأجل أحبائه" (يو15: 13).. وطالما البذل كان بحب بل بأعظم حب، فهو يقيناً
بلا غصب ولا قهر إرادة ولا حتى محاولة لإخضاعها دون موافقة من قلب عمقها.. إنه حبّ
وأعظم حبّ فلا مكان للغصب إلا غصب الحبّ.. والربً فوق هذا يقول بكل وضوح: "ليس احد يأخذها مني بل أضعها أنا
من ذاتي.لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا" (يو1: 18).. فما الذي قصده الرب في ليلة صليبه بكلمته
الخطيرة التي تظهر تمايز الإرادات بينه وبين الآب؟ إنه أراد إظهار التعارض – وكيف يظهر بأفضل
تعبير؟ لو نسب محبة الصليب لنفسه لغطّى على صعوبته عليه، ولو نسب كره الصليب للآب
لغطّى على محبته لفداء البشر.. ولأنه هو المتكلّم فكان اللائق بحسب أصول الكلام
وتأثيره في البشر أن ينسب المحبة للآب (دون أن ينفيها قطعاً عن نفسه) وأن يعلن
صعوبة الصليب على نفسه لأنه بحسب الظاهر واقع عليه هو وهو الأولى منطقاً بالتعبير
عن قسوته.. وأي مساومة مع هذا التفسير تصدم صاحبها في
شاهد كتابيّ ثابت.. وبإثبات اتفاق إرادة الآب والابن تزول مظنّة التعارض
بينهما، والذي على أساسه عُلِّقَت الحجة الكتابية الظنيّة بالإثنينيّة غير القابلة
للواحديّة بين إرادة الناسوت واللاهوت في الابن.. وثبتت الإرادة الواحدة من الإرادتين.. ولكن الغرادة لها خصوصيّة عن الطبيعة، واتحاد
الإرادات أسهل في تغييب التميّز في التصّور البشريّ؟ فما معنى تميّز
الإرادتين؟ الإرادة ليست مجرد توجّه أو نزعة أو قرار،
ولكنها تجمل معها بالضرورة جوهر العزيمة.. وحتى كلمة إرادة في الأصل اليونانيّ اشتُقَت
منها كلمات Athlete and Athleticsفي اللغة
الإنجليزيّة المُتَرجَمة نشيط وبطل رياضيّ.. فإذا كانت اتحاد الإرادات يوحدهما دون أدنى
تمييز على مستوى الغرض والاستحسان والرذل، فإن العزائم تتميز بوضوح.. فالروح نشيط
والجسد ضعيف، وبالأولى اللاهوت فائق والناسوت محدود.. وهذا التميّز يظهر بكل وضوح أمام آلام الصليب،
فالإله يرفض الخطيّة، ونفس المسيح لمتحدة بلاهوته ترفضها وتتألم من عارها.. ولكن
الجسد الماديّ يتألم من الجلد والشوك والمسامير بأكثر مُباشَرَة.. وصحيح يحدث
اتصال في أثر العزيمة في كل عنصر على بقية العناصر بفضل الاتحاد الشخصيّ الطبيعيّ،
مثلما يتبادل الجسد والنفس الأثر والتأثّر في الإنسان الواحد، ولكن مع الوحدة يبقى
التميّز قائماً.. هذا التميز في الطبائع (الذي لم ننكره قطّ)
يظهر في النظرة التفصيليّة في فحص إرادة الفعل ورد الفعل التي تبقى واحدة
في المسيح، تتقدَّم لغاية واحدة مدفوعة بدافع واحد ولكنها تتميز في مظاهرها بين
اللاهوت والناسوت مثلما هي هكذا بين النفس والجسد والروح في إنسانية الرب.. هي إرادة واحدة
من إرادتين، بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير؛ لأنها إرادة طبيعة واحدة من
طبيعتين بدون اختلاط ولا امتزاج... ولا تغيير.. وبغير هذا التغيير في كل أبعاده فإن اتحاد
الطبائع بدون اختلاط ولا ماتزاج ولا تغيير لا يكون له لزوم حاشا.. التغيير في طبيعة المسيح الإنسانيّة كانت أساس
من أُسُس حقيقة التجسد.. كان يتغيّر عبر رحلة حياته كإنسان، من جنين
لطفل ينمو في النعمة والحكمة والقامة إلى رجل مكتمل الرجولة، حتى مات وقام.. وأعظم التغيّرات عندما
تغيّر جسده بالقيامة.. لو لم يجتز رحلة التغيّر ما بارك كل مراحل
رحلة الإنسان وما كان متأنِّساً بالحقيقة، ولا كان للتأنّس حميميّته عنا ومفعوله
في إتمام فدائنا.. ولو لم يتغيّر التغيّر الأخير العظيم بإظهار
تمجُّد جسده ما صار لنا صعود معه وجلوس عن يمينه.. إذاً فقد اجتاز الرب إنسانيّاً حال التغيّر.. و"كلُّنا نتغيّر" (1كو1: 51).. "سيغير شكل جسد
تواضعنا، ليكون على
شبه جسد مجده" (في3: 21).. "أيها الأحباء الآن ننحن أولاد الله ولم
يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه متى أُظهر نكون مثله
لأننا سنراه كما هو" (ايو3: 2-3).. وبدون هذا
التغيير لا لزوم للتجسّد أصلاً ويكون الرب قد
قام بعمل لم يحقَّق غايته - حاشا إن رحلة طبيعة
الإنسان المتغيّرة في ذاتها، ظهرت بشكلها في المسيح بذات تغيراتها بريئة من الخطية.. اتحادها
باللاهوت
لم يغيّر من تغيّراتها! إن الرب أخذ رحلة
الإنسان كما هي بكل تغيراتها الطبيعيّة بغير تغيير لا تغيير في
إنسانيتها، ولا تغيير بسبب اتحاده بها في لاهوته الذي يبقى بلا ظل تغيير ولا دوران
(التشبيه ماخوذ من تغيّر مقياس الزمن والقصد أنه الرب لا يتغيّر مع أحداث الزمن) ولكن الرحلة
الإنسانيّة في ذاتها تتغير من شكل لآخر ومن مرحلة لأُخرى وتغييرها الأعظم
هو تمجيدها بنعمة الرب بقيامة الحياة الأبديّة بلبس الجسد النورانيّ حين
"نُقام في عدم فساد، في قوّة، وفي مجد الأجساد الروحانيّة" (اكو15:
42-43).. فكيف يُقال بلا
تغيير؟ إن عدم التغيير
هنا هو عدم تغيير التغيير إن الثبات دون
تغير هنا هو ثبات شكل التغير ذاته الذي اجتازه الرب جميعاً ليصنع صورة الإنسان
الكامل كما أراد الرب وهذا الغرض يُسمَّى شركة الطبيعة الإلهيّة،
وإلا فكيف لا يُسمَّى هكذا؟ شركة
الطبيعة الإلهيّة ووحدة الطبيعة في المسيح فكيف نشترك في الطبيعة الإلهيّة وتكون لنا
طبيعة واحدة، مع تميز الأشخاص: شخص الإله يبقى غير شخوص البشر، وشخص كل إنسان يبقى
متفرداً في شخصه، كيف نشترك في طبيعة
واحدة أشخاصاً كثيرين، والشخص الواحد الذي صنع هذا برصيد فدائه ليس له طبيعة
واحدة؟ إن طبيعة الإنسان
المخلوق أصلاً على صوره الرب الإله تصل أن عند اتحادها في التجسد فيما يخص شخص
المسيح تمثل انطباق النسخة الأمثل على الأصل.. ولذلك فالتجسّد هو من
طبيعتين، عند اتحادهما يصيران طبيعة واحدة تحمل سمات الجميع.. إن غاية الرب المُعدَّة
للإنسان أن يتغيّر على شكل جسد مجده ويسيّره في شركة الطبيعة الإلهيّة من
مجد إلى مجد، تحتِّم أنه بالأولى يقوم المسيح في طبيعة واحدة.. إن الكنيسة اليونانيّة
تبنّت بكل إخلاص وعناية الكلام عن التألّه ونوال النور غير المخلوق، ويعوزنا الوقت
إن فصّلنا كلام مكسيموس المعترف وغريغوريوس بالاماس ومن سبقهما ومن لحقهما.. فأتعجّب
كيف أنها احتفظت بهذا ولم تلتفت لما سبق لها فواته بتعسف واضح، أن شركة الطبيعة
الإلهيّة تكون بالأولى للرب المتجسد صانعها ودافع ثمنها للمؤمنين.. وإن اشتركنا اشخاصاً
في طبيعة واحدة، فبالأولى أن يكون الشخص الواحد، رأس كل
الأشخاص، في طبيعة واحدة.. ورغم أنني لا أميل
لاستخدام المصطلحات التي يصطلحون عليها بغير لغة الكتاب المقدس، لكنني أقدِّم
المعنى على اللفظ رغم هذا، وطالما وافق اللفظ المعنى الصحيح فلا أمانع فيه، فيحقّ
لي من ثمَّ التعجّب عن حال الذين يسرفون في المصطلحات المولَّدة التي تسترسل في
وصف شركة الطبيعة الإلهيّة، ويخلصون في شرحها ويعتنون بالاحتفاظ بها، ثم يعاندون
في القول بالطبيعة الواحدة؟ الطبيعة هنا هي الفيزياء.. طبيعة
الخليقة J وليست
طبيعة المسيح! وكلمة فيزياء مأخوذة من الأصل اليونانيّ لكلمة الطبيعة التي تعايشنا
معها طوال هذا الصراع.. إنها صدفة ليفة أن يقدم لنا "علم الطبيعة"
المخلوقة شهادةً لقضيتنا.. من أكثر المصطلحات التي استوقفتني في الفيزياء
هي: The dual nature
of the electron إذ فوق إِلغازها العلميّ
المغري بالفحص، فقد تذوّقت فيها إشكالية علمية تشبه في دقة شرحها إشكالية الحديث
عن طبيعة المسيح.. ولكن بغض النظر عن أي صعوبة منطقيّة في الشرح
أو الفهم، فإن الذي أضع تحته خطّاً والتقطه شاهداً لي هو بساطة التعامل مع اللغة
هنا.. إنهم يقولون "طبيعة مزدوجة" و"طبيعتين"..
يقولون التعبيرين معاً دون أن يفكِّر أي عالم في تخطئة التعبير الأوَّل بحكم
الثاني.. إنهم يفهمون أن ازدواج الطبائع يُعَبَّر عنه بوحدة الطبيعة (دون اختلاط
ولا امتزاج ولا تغيير J).. لا أهذي بل أتكلّم كلا الصدق والصحو، فإن
طبيعتيّ الإلكترون متميزتين تماماً ولا فرصة ولا حتى فكرة في إمكانيّة تحوّل
إحداهما للأُخرى، على الأقل وقت نشوء الاصطلاح.. فالإلكترون يسلك سلوك الجسيمات في
ظروف ويسلك سلوك الموجات في ظروف أُخرى.. وإذا كان التعبير يسير بسلاسة هكذا على
الإلكترون الذي لا تجتمع فيه الطبيعتنان في وقت واحد، فكم بالأولى جداً أن
يصح التعبير في وصف مثال الرب الذي تقوم فيه طبيعتاه المقدستان في كل وقت دون
انفصال ولا للحظة أو طرفة عين؟ والمثل موافق جداً لموضوعنا، لاسيما أن لغة
العلم دقيقة يعتني بها العلماء أيما عناية.. وبهذا الفصل الطريف أُنهي الفحص الموضوعيّ
للقضيّة، الذي قصدته قصيراً، ولا أحب أن أستفيض أكثر من ذلك في إيضاح الواضح..
وتبسيط البسيط.. وأتساءل لأجيب: كيف نجح الشيطان في تعقيد البسيط على فرط بساطته؟ إن أعقد الأمور هو تبسيط البسيط والإقناع
بالواضح.. ولهذا طال المقال الذي كفته الفقرة الأولى لمن لم تتعقَّد مخيلته بتراكم
المدخلات التاريخيّة والحذلقات المتكررة والتعصّب اللامسيحيّ.. ولان تبسيط البسيط طال، وإيضاح الواضح تكرَّر
من عدة مداخل، فلزم التلخيص.. وأبدأ بالإقرار أن الصياغات الخالكيدونيّة/
ليس فقط تلك التي وضعناها طيلة الوقت تحت مجهر الفحص، بل وكل الصياغات
الحلقيدونيّة بلا ادنى تحفّظ، هي صحيحة شرط ألا تكون بمعنى رفض القول بالطبيعة
الواحدة.. ولأنها صحيحة، والصحيح لا يناقض الصحيح بل
يتفق معه، فقد ظهر أنه وبكل الطرق ومن كافة مقاطعها نصل للقول بالجملة الأولى
الأثيرة: المسيح 1) أقنوم واحد من 2) طبيعتين
متحدتين، وظهر أنّ: 1- القول
بأقنوم واحد يصل للقول بطبيعة
واحدة 2- والقول
بطبيعتين متحدتين يصل للقول بطبيعة واحدة فماذا بقيّ من قولهم ا
يصل لقول الطبيعة الواحدة؟ ومِمَّ يقلقون بعد كل ذلك؟
أن طبيعة المسيح واحدة فريدة في وحدانيتها إذ: تجمع دون ابتلاع وتتًّحِد دون تغيير والتي فيها وحدها يكون اتحاد الكنيسة مع
الابن والآب والروح القدس جميعاً.. والآن وإذ قد فرغتُ من فصول الموضوع المعنيّ
بالأسلوب التام الموضوعيّة بعيداً بقدر الإمكان عن الأحداث والأشخاص، فيمكن الآن
أن أُفسِح بعض المجال لإضافة فصول للخواطر المناسبة في الأحداث والمعاني المصاحبة
الرئيسة التي أحاطت وحاربت هذا التعبير البسيط عن طبيعة المسيح الواحدة.. إن كل المداخل لغويّاً
وتفسيريّاً وتلقائيّاً وروحيّاً، لا تجد أدنى غضاضة في القول بطبيعة المسيح
الواحدة في شخصه الواحد، ولكنّها كلمة "الواحد" و"الواحدة" هي
التي ترعب الشيطان، فأخفى لزوم بساطة وبساطة لزوم هذه الكلمة البسيطة اللازمة،
وانطلق يمرح في التفاصيل، تفاصيل مفردات وشروح، وتفاصيل أحساد ومخاوف.. كل هذه هي
الأمور الدخيلة هي المعقَّدة المتسبِّبَة في التعقيد، وأما أصل الإيمان فبسيط
بساطة المسيح الواحد.. ولكنّ الشيطان وجد لنفسه مدخلاً ليفسد بساطتنا
التي لنا في المسيح حين أوسع الرؤساء
فجوات في سور الكنيسة فضيّقوا عليها رحب الرب.. لقد دعانا يسوع وقال: " أنتم
تعلمون أن رؤساء الأمم
يسودونهم،
والعظماء
يتسلطون عليهم. فلا
يكون هكذا فيكم " (مت20: 25-26)..
ولكن صار هكذا فينا!. علَّمنا الرب أن: "ملوك الأمم يسودونهم
والمتسلطون عليهم يُدْعَوْن محسنين وأما أنتم فلستم هكذا" (لو22: 25)..
ولكن بعضنا صار هكذا! فينا من عبثوا بوصيّة
الرب واستخفّوا، وصيّروا فينا هكذا، فأورثونا مرارة ثمار مخالفة الرب.. إن صفحة واحدة من مفتتح أعمال المجمع أو ختامه
تصرخ بأوقح الصراخ ضد وصيّة الرب.. فالكل هم "القضاة الأماجد" و"صاحب
الوقار" و"صاحب أعظم الوقار" و"التقيّ" و"الأكثر
تقوى" و"القديس" وكليّ القداسة".. ولا أخص باللوم مجمع خالكيدونا
فقد بدأت نزاعات قبول المجد بعضهم من بعض قبل هذا المجمع واستمرت بعده حتى يومنا
هذا، ولكن عندما نضع شيئا على النار يصل حتما للغليان وقد وصل في هذا المجمع [v].. وعند فتح صفحات مجمع أفسس الثاني أمر الآمرون
بتأجيل مناقشة صياغة الإيمان حتى يفرغوا من مناقشة حكم رئيس الأساقفة على أخيه
رئيس الأساقفة الآخر.. وكان منطقيّاً مناقشة الإيمان الذي بناء عليه تكون مناقشة
الأحكام على الأشخاص، ولكن كانت هذه علامة على أولويّات أهل المجمع [vi].. فإذا كانت هذه بداية وأكثر الكلمات تكراراً في
المجمع، ثم كانت هذه أولويّاته، يكونوا قد اجتمعوا اجتماعاً ليس من عنده،
وتكون نهايته الانقسام المُحتَّم، وتكون نهايتنا، وينبغي أن تكون، هي التبرؤ من كل
هذا العبث، الذي إن لم ننته عنه، وننته للتبرؤ منه، فسننتهي به.. سننتهي! ولكن الرب قائم في وسط
تاريخ الكنيسة ينقض أعمال إبليس.. ومن افتقاد الرب وسط كل هذا كان خطاباً لم
يتوقَّف الكثيرون عند دلالاته الضاربة في اتجاه ماضيه، والمؤثرة أثراً خطيراً
مشكوراً في مستقبل ما بعهد حتى أيامنا هذه، وأعني خطاب الوحدة الذي أرسله البابا
كيرلس الأوّل إلى الباتريارك يوحنا الإنطاكيّ.. وهذا الخطاب يحمل من الآثار في كل اتجاه ما ينبغي
للمتأمِّل قبل العالِم أن يمعن النظر فيه..
إن كل ما أصاب فيه هذا الخطاب بقيت منافعه لليوم راسخة.. وكل ما قَصر عن
معالجته عاد بعد أقل من عقدين من السنين ليزلزل الكنيسة ويحدث بها الانهيار الباقي
آثاره لليوم.. ولنا منه في هذه العجالة:- ·
تلاقي مدرستَي إسكندريّة
وإنطاكية بعد طول افتراق.. ·
مقابلة الخطاب مع رد البابا
كيرلس على كتابات ديودور، وأخطائهما وتلافيها في الخطاب.. ·
دور السلطة في إقرار الإيمان،
والعِبَر من هذا! ·
طريقة تجاوز عجز اللفظ.. ·
رد فعل أساقفة الإسكندريّة
المناوئ ومدى أحقيّتهم.. (بسبب دقة الآراء
في هذا الفصل، فهو مُؤجَّل العرض لحين استكمال إثبات المراجع) بدأتُ بقولي إنني قبل
شهر، ما كنت أصدِّق أنني الآن بعد كل هذا أصرف وقتاً وجدهاً لمعالجة هذا الموضوع! وأما هذا الذي جعلني لم أصدِّق صرف الوقت والجهد في هذا الموضوع، فهو رحلة طويلة
سابقة لكل جيلي في درس هذه القضية، انتهت بنتيجة سخافة الأمر وحتميّة زواله كزوال
الضباب في لا وقت وبغير جهد، عندما يتحسّن حال الريح والروح.. وانتهت رحلتي
مبكِّراً بالانشغال بوحدة الكنيسة والعودة للأصول النقيّة بكل قوة.. ولكن في لحظات نهاية
النهاية لاحظت عودة إبليس للتفتيش في دفاتره القديمة، ولاحظت انشغال شباب
"مثل الورد" في هكذا موضوع انشغالاً نفسيّاً مؤلماً، وليس مجرد نطاعة
ونزق فكريّ.. ومتعاطفاً معهم لاسيّما بالنظر لسابق ما مررت به في رحلة هذا الموضوع
كتبتُ ما كتبتُ أعلاه.. ولا مانع من ألقاء ضوء على خلفيّتي في الموضوع، حتى تكتمل
عناصر الشهادة.. كان مطلع جيلي يقرأ لاثنين أو ثلاثة معدودين، ولم
تكن من قضاياهم فتح أبواب التاريخ والصراعات الثيولوجيّة، ولم تكن مادتهم تزيد عن
تكرار المتكرر بصحيحه وخطئه، ولم ينس أي واحد منهم مداومة التأكيد في ثنايا السطور
على صحة المذهب الأرثوذكسي.. ولكنني وقعتُ على
إشارة مذهلة أن كنيستنا محرومة وليست أرثوذكسيّة وأن الانقسام
الكاثوليكييّ\الارثوذكسيّ، أو بالأحرى الغربيّ\الشرقيّ لم يقع في خالكيدونا
"المشئومة" في الصراع "الخريستولوجيّ"، وإنما وقع بعد ذلك
بعدة مئات من السنين في صراع فيليوك أو انبثاق الرح القدس! وأما ما حدث في خالكيدونا
فكان اتفاقاً من الجميع على عدة كنائس "صُغرى" بالنسبة لهم، منها
كنيستنا التي كانت في حسابهم مجموعة الفلاحين في بعض الأقاليم، وليس كنيسة
الإسكندريّة الفخمة، لم يُنظَر لها بعد ذلك من الباقين قط أنها أرثوذكسيّة.. نحن
لسنا أرثوذكس في حساب العالم؟ وهم يخبئون عنا هذه الحقيقة المسكونيّة؟ في الجولة الأولى
كانت مشكلتي في جهل الجيل المحيط كله بهذه الحقيقة.. فكيف اناقش قضية خطيرة في
مكان مناقشتها الطبيعيّ، الكنيسة، بينما لا يعرف أي واحد تقريباً أي شئ عن
الموضوع؟ وفي الجولة
الثانية كانت مشكلتي في الوقوف على مصادر موثوقة أصيلة تعينني على بحث
القضية.. وفي الجولة
الثالثة بدأت أنزعج بقوة من اتجاه ملموس من كبار الإكليروس إلى التسامح
بشأن هذه القضية والتماس الحلّ عن طريق افتراض اتفاق الإيمان واختلاف الصياغات.. فإن
كان ذلك كذلك فلماذا سبقوا وشحنوا الجميع بالعقيدة المُسَلَّمة والهرطقة المبينة
والأمانة المستقيمة وفي الجولة
الرابعة وقد زادت خبرة ضميري فلم أعد أحكم بالعلم للجهلاء ولا بالأمانة
للمستغلّين، وقفت على حقيقة القضية بعيداً عن التعصب المبني على مبدأ "لابد
وينبغي ولا بديل خلاف أن كنيستنا وكل إكليروسها على حق كل الحق ولاشئ غير الحق".. وفي الجولة
الخامسة حكمت بوضوح إن الفُرقاء، تبادلوا المواقع وتكلّم كل واحد بعبارة
خصمه، ولم يعد للانقسام أي معنى إلا المعنى السلطويّ.. وفي الجولة
السادسة وجدتُ انه لم يتوقف أي واحد ليسأل: ما عنى كلمة طبيعة؟ لم يسأل عن
معناها عند خصمه ولا عند نفسه حتّى، ولو فعلوا لاكتشفوا أن فريقاً يقصد بها
"الجوهر-الخواص" وفريقاً يقصد بها "الشخص- الأقنوم" وعليه
فالخلاف ليس في معنى الصياغات ولكن في فهم قصد المعنى أصلاً .. (بالمناسبة فإن
التمييز بين الأقنوم "ايبوستاسيس" والجوهر "اوسيا" كان
تمييزاً نبّر عليه باسيليوس متأخراً في حين كان مجمع نيقية وأثناسيوس يستعملان
الكلمتين في تمام التماهي!! ولكن تلك قضية آخرى، وإنما لما كان الفصح هنا هو لتعبير "طبيعة" وكان التمييز بين
المعنيين الأقنوم والجوهر حاضراً متمثلاص في كلمتين صريحتين بحسب اصطلاح باسيليوس
فإن الخلاف كان يمكن مراجعته لو كان لفظياً محض وان كنتُ أراه كان أبعد من مجرد
خلاف لفظيّ وقتها، فأما الآن وإذ صار الخلاف لفظياً بحسب مراجعة كل طرف لما داخل
ناجيته من أخطاء أو شبهتها فإن هذا يلقي على الصراع الهازل مزيداً من اللوم) وفي الجولة الثامنة مع الشغف
بمتابعة مجهود الوحدة في المجامع توقّفت بغضب عند عقبات غير منطقيّة، وهي عقبة
المجامع وعقبة الحرومات على الأشخاص.. فلقد اتفقوا على معنى الإيمان وعطّلهم عن
الوحدة عدم اتفاقهم في الحكم على السابقين، وعلى مجامعهم: أيهم قصد ما اتفقوا عليه
وأيهم قصد خلافه؟ هذا الخلاف مجدي وله معنى حال وجود هؤلاء معنا على الأرض، أما
وهم عند الرب، ولا يبقى لدينا منهم إلا تاريخ لا نضمن سلماته تماماً، ولا نضمن عدم
سقوط شئ منه أو دس شئ فيه، فالقضية تسقط شكلاً، وتصديرها هو من باب العصبيّات
الموروثة ليس إلا.. وفي الجولة الثامنة
رأيت أن ما لاحظته سابقاً قرّره علماء (حون رومانيدس مثلاً) واتفق عليه لحلّ
المشكلة مجامع بزيّها - فالاتفاق الذي صار على صياغة موحَّدة في دير أنبا بيشوي
القبطيّ سنة 1991 عالج المشكلة بطريقة لا يلتقطها إلا من سار مسيرتي: لقد حذفوا
كلمة "طبيعة" تماماً"، تلك التي أشكلت على الجميع، ومع حذفها انحلت
المشكلة، واتفقوا أن المسيح واحد، كامل في ناسوته ولاهوته المتحدّيْن معاً.. يا
سلام؟ ما كان من الأول! وفي الجولة التاسعة
صار لي صداقات مع كثير من أبناء وإكليروس الكنيسة الأرثوذكسيّة الشرقيّة[vii]..
وأتذكّر فيهم من كان يغضب بقوة لصداقة
رفاقه لقبطيّ "غير رثوذكسيّ"
وأتذكّر
كيف كدَّرت واحداً من هؤلاء بحكم الخبرة "الأرثوذكسيّة" في تعقيد
المتعصّبين J.. لقد أوصلته مرَّةً لواجهة حقيقة أن فكره يحتِّم عليه الإقرار
بأنه الأرثوذكسيّ الوحيد في العالم، وبهذا تسقط نظريته بالجملة، لان الأرثوذكسيّة
مبنيّة بالضرورة على فكر كنسيّ لا فرديّ! وتركته معذَّباً في مواجهة هذه النتيجة
التي لا يملك مواجهتها ولا يملك تكذيبها، وليس لها من حل غير مراجعة نفسه وهو أصعب
الصعب على المتعصِّب.. وعلى سياق استدعاء
الذكريات الفَكِهَة، أتذكَر حوار دار بيني وبين أسقف الشباب أنبا موسى بهذا الشأن،
وقلتُ له إن الفكر "الأرثوذكسيّ" سواء نحن أو اليونانيين ينحو لفكرة
عصمة المجامع، وإن كانوا هم أكثر اتساقاً في نظرتهم لأن لدينا من المجامع
القانونيّة ما نرفضه وليس هذا هو حالهم فقال لي دعابة علّقت
عليها بما زادها مداعبة.. قال لي: "ما هو انت
تعرف الطوايف بسؤال عن المعصوم عنده، الكاثوليكي يؤمن بعصمة البابا والبروتستانتي
يؤمن بعصمة اللاهوتي المنتمي لمذهبة، والأرثوذكسي يؤمن بعصمة نفسه".. تظاهرت بالرفض لهذه
النتيجة جادّاً، فكلّمني بلطف على جديّتي، وقال لي: "دي نكتة يا حبيبي ماحنا
بنقول ده غلط".. فقلت له مواصلاً تظاهري
بالجدِّيَّة: "أكيد غلط ازاي يؤمن بعصمة نفسه؟ المفروض يؤمن بعصمتي أنا".. فضحك بقوة وعَلَّق:
"طمنتني عليك - انت كدة أرثوذكسي".. وفي الجولة العاشرة اشتممت
رائحة الوحدة الكنسيّة العزيزة مع ارتياحي، وقتها، للجو الإيمانيّ للأرثوذكس
الشرقيين في الولايات المتحدة، ولاسيما مع كثرة المتحولين من مذاهب أُخرى إليهم، واستعدت
مقولتي الحماسيّة: + عندما يتَّحد الأرثوذكس ستتحد الكنيسة،
وعندما تتحد الكنائس سيؤمن الجميع.. وفي تعليقي على خلافات حول الطقوس الغربية في
الكنيسة الأرثوذكسية قلتُ: + No matter you go
eastward, or you go westward, as long as you go Orthodoxward! ومثل هذا الكثير، وكثير
من المساهمات يجدها الباحث في منتديات الكنيسة الأرثوذكسية الشرقيّة على ياهو.. وأظن
أنني كنت على حافة الانضمام لهم رسميّاً، منعني وقتها مثال موسى الذي احتمل عار
المسيح حاسباً إياه غنى أعظم من حزائن مصر، وبكل صراحة كنت أحسب حال الكنيسة
القبطيّة في عار، ولكني قلت أحمله طالما لا يصل للارتداد عن المسيح.. ولو حسب الرب
عار الكنيسة على نفسه، إذاً لحُسِبَ لي أغنى من خزائن الولايات المتحدة.. وهكذا
بقيت متحمِّلاً العار ناقضاً له رغم إيمان وغيرة ومحبة وترحاب أهل تلك الكنيسة..
ولكن مع الخبرة وتزايد الاطِّلاع على حال كنيستهم وصلتُ لنتيجة أفضل ما يقدِّمها
هذا المثل الشعبيّ: ما أسوأ من سيدي إلا ستِّي.. أقدمه خلاصة رحلة لكل من تراوده هذه الفكرة
المجنونة J وفي هذه الجولة الأخيرة لي مع رحلة الطبيعتين
المتحدتين والطبيعة الواحدة، التقطتُ لآلئ ثمينة من الأقوال.. قال مرَّةَ لي الأب كونستانتين (أمريكي
متحوِّل من الكنيسة الأسقفيّة) بسخرية بديعة: + What stands for obstacle against
church unity is not differences in formulae. It is disagreement over titles. We
are ready to receive his holiness your patriarch, if he is ready to
accept his most holiness our patriarch! وعبارة حكيمة محفِّزة قالتها
باربرا جوتمان (متحوِّلة للارثوذكسيّة من
اليهوديّة بدعوة إلهية غاية في البساطة)، قالت لي وأنا أناقش همّ وحدة الكنيسة
مرَّة: +
Unity will go up from the base Vasili, not come down
from the head of clergy.. وأضفت: + It comes from above through the grace of Christ. But you add
to its roadmap where it will settle first in the church, than one knows where to
start searching for.. Well said Barbara.. آمين يا رب، في
الانتظار،،، وأوقِف حديث الذكريات مع
هذه الجُمَل المستبشرة وإلا طال وتاه منِّي ختامه،،،،، [i] عندما بدأت تقديم
موضوع "الطبيعة الواحدة للمسيح" كان جمهور القصد هو التحزّب الأعمى
الرافض لتعبير لا يفهم هفهماً صحيحاً لغةً ولا منطقاً، ويبنى على عدم الفهم
أحكاماً إيمانيّة وكنسيّة فادحة الإشكال، فكان الموضوع كمنا ظهر أولاً وتلقّى
ترحاباً كريماً يواجه تلك المشكلة، على أن حلها لا يعني أنه لم تكن ثمّة مشكلة
حقيقيّة أو أن الإشكال انحصر في خلاف لغويّ لمعنى كلمة، وما أهزل هكذا تصوّر يحيل
أحكام الحرمان والحنق والخصومة إلى درس في النحو والضرف فات الأساقفة، وإنما كان
واقع الإشكال فوق الخصومات الشخصيّة، وفوق مشكلة الخلاف في فهم كلمة، وكل هذا صحيح
وواقع، ولكن كان فوقهما إشكال عدم استعداد لغويّ منطقيّ تفسيريّ عميق، ولاحقاً
أضفت هذا البوست وبه بدوره روابط لغيره مما يحيط بكثير ن أوجه ومستويات الإشكال
الأسيف: https://www.facebook.com/christopher.mark.5095/posts/10155005823359517 [ii] هذا العنوان لا يحمل جديداً في ظاهره، وقد تكلّم
كثيرون طوال الصراع مستندين له، حتى نُسَب لأنبا ساويرس الإنطاكي بعض التزوَّد
الذي لا أقبله، وهو أن الطبيعة الواحدة لها بالضرورة شخص واحد، وبالتالي فالمسيح أقنوم
من أقنومين متَّحدين.. هذا كلام غير صحيح عندي، فالطبيعة الإنسانيّة في المسيح لم تكن
قطّ أقنوماً مستقلاً اتحد مع اقنوم المسيح الإله فصارا اقنوماً واحداً، فليس
بالضرورة أن الطبيعة الواحدة يكون لها أقنوم واحد، او حتى يكون لها أقنوم أصلاً.. وما حدث في تجسّد الرب
أنه لحظة حلول الروح القدس على العذراء مريم وعمله في أحشائها هي ذات اللحظة التي
صارت فيه خليّة إنسانية عاديّة، (بلا أقنوم يختصّ بها منفردة)، صارت فيه خاصة
بأقنوم المسيح ومتحدة مع طبيعته الإلهيّة.. ليس هذا على كل حال هو
مدخلي للشرح، وإنما لزمت الإشارة للتداخل.. [iii] (كالقول في أحد
الألحان: هذا هو الإله مخلصنا ورب كل ذي جسد – وأصلها رب كل جسد في اليونانيّ: “كيريوس
باسيس ساركوس" ؛ وفي القبطيّ: "إبشويس انساركس نيوان”) [iv] القضيّة هنا حتى لا تختلط عناصرها
على الناظر هي قضيّة نصّ إنجيليّ منه معنى صحيح ومظنون عليه معنىً خاطئ، وعمل
المفسِّر هو إثبات الصحيح منه وإثبات خطأ الخاطئ!! المعنى الصحيح النابع منه
إيجابا وهو اتّحاد طبيعيّ شخصيّ بين لاهوت شخص الكلمة وبين طبيعته الإنسانيّة التي
أخذها من العذراء، هذا معنى لاحق بالضرورة من النصّ، على أن نفس النصّ تتماحك فيه
مظنّة غير صحيحة لمعنى آخر مرفوض وهو استحالة الطبيعة الإلهيّة لطبيعة إنسانيّة..
وفي رفض المعنى الخاطئ تكلّم أثناسيوس وتكلّم ثيودوريت والواحد يتكلّم هنا بدوره
ولم يقبل هكذا معنىً خاطئاً إلا أوطاخي
وبعد التائهين من السكندريّين، فلا إشكال في رفض المعنى الخاطئ ذاك، ولكن
البعض فيما يزيل المعنى الخاطئ يزيل معه المعنى الصحيح ظانّاً أن كليهما واحد وتلك
عقدة من العقد الرئيسة في فشل التفاهم والفهم في جدليّة التعبير عن التجسّد، ولقد
وقع في هذا الخطأ بكل أسف ثيودوريت فيمن وقعوا، وحاول هذا الأسقف البارع في
المكتوب والمنطق أن يتحايل على المدلول الإيجابيّ الصحيح للمكتوب، بقصد تخطئة
تعبير "طبيعة واحدة متحدة"، محارباً غياه كأنما هو يتماهى مع القول
باستحالة الطبائع، فقرن بين النص الإنجيليّ الخطير وبين وعد نبويً أقل تحديداً لكيفيّة
التجسّد وهو قول كاتب العبرانيين: "لأنه حقاً ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل
إبراهيم" (عب2: 16).. ثم لجأ للحيلة الأشهر لتحويل معنى أي كلمة، وهي
اللجوء لنص مشابه الألفاظ مخالف المعنى حتى يثبت أن للكلمة معنى غير المعنى.. ووجد
منشوده في قول الرسول بولس : "المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة
لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من عُلِّق على خشبة" (غل3: 13)، وبسعة
اطلاعه فقد استشهد لهذا بشرح من رسالة البابا أثناسيوس إلى إبكتيتوس ونقل الفقرة
منه ولكن ليس تماماً كما كتبها أثناسيوس، ولا لتصل إلى ذات غاية أثناسيوس، بل ليقف
بها عند حدود فهمه الصحيح في ذاته (أي رفض تحوّل الجوهر الإلهيّ) والخاطئ في رفضه
لتمام المعنى (أي رفضه لأن صيرورة الكلمة جسداً وإن لم تعني تحول طبيعته الإلهيّة
فإنها تعني اتحاده اتحاداً طبيعيّاً لطبيعة واحدة جامعة للطبيعتين).. فهكذا نقل من
أثناسيوس: “Hear then how he wrote to Epictetus.1 "The
expression of John `the Word was made flesh' has this interpretation, so far as
can be discovered from the similar passage which we find in St. Paul `Christ
was made a curse for us.' It is not because He was made a curse but because He
received the curse on our behalf that He is said to have been made a curse, and
so it is not because He was turned into flesh, but because He took flesh on our
behalf, that He is said to have been made flesh."” (NPNF, Series II, Vol 3, Theodorete, Dialog On
Mutation) ولو كان البابا أثناسيوس
توقَّف عند ذات غاية ثيودوريت لوجب تقييم قوله بذات تقييم الرافضين القول بـ
"الطبيعة الواحدة"، والذي هو "قطع جزء من المعنى والتوقف دون
الوصول لنتيجته اللازمة خوفاً من الوقوع فيما هو أبعد، ولكن وبكل حقّ فليس هذا
تعليم وفهم البابا أثناسيوس، والذي لن يُهمَل إثبات نصه الأصليّ، وشرح غايته في
الفقرة الأخيرة من هذا الهامش.. لقد أساء ثيودوريت فيما قال فهم النصّ
الكتابيّ وتفسير البابا أثناسيوس جميعاً، فإذ شُبِّه تجسد الكلمة بصيرورة الرب
"لعنة" لأجلنا، حسب فهمه لهذا، فيكون التجسد بموجب قوله ذاك بالضرورة،
قصد أم لم يقصد، مجازاً مرسلاً علاقته المصاحبة، أليست هذه كلمة نسطور في
تطرفها البغيض؟!!! وحسناً أن الخالكيدونيين انتهوا بحرمان كتاباته، فهي مستوجبة
الرزل مع حفظ تكريمه الشخصيّ بما هو أهل له، ولعله يخلص كما بنار.. إن فهمه للنصّ الكتابيّ قاصر ونقله لتفسير
أثناسيوس مُختَطَف!! فأما قول الكتاب "المسيح... صار لعنة
لاجلنا" فكلمة "صار" هي صار.. الصيرورة هنا صيرورة إلحاق أمر
مزيد بشخص المتقبِّل لهذه الصيرورة، وليست صيرورة تحول لطبيعة الشخص.. وأما أنه نقل الشرح من أثناسيوس ففي هذا نظر
دقيق.. وها هو نص أثناسيوس: " 8. These
things being thus demonstrated, it is superfluous to touch upon the other
points, or to enter upon any discussion relating to them, since the body in which
the Word was is not coessential with the Godhead, but was truly born of Mary,
while the Word Himself was not, changed into bones and flesh, but came in the
flesh. For what John said, `The Word was made flesh ,'
has this meaning, as we may see by a similar passage; for it is written in Paul:`Christ has become a curse for us .' And just as He
has not Himself become a curse, but is said to have done so because He took
upon Him the curse on our behalf, so also He has become flesh not by being
changed into flesh, but because He assumed on our behalf living flesh, and has
become Man." (Athanasius
of Alexandria, Letter LIX, NPNF, Vol 3, Series II, Paragraph. 8) الواضح
من النصّ الأثناسيّ الكامل،
مثلما هو واضح من الصيغة التي صاغها عنه ثيودوريت، أن مقابلة القول الإنجيليّ مع
القول الرسوليّ يصب رأساً في إثبات أت "الصيرورة" هي ليست صيرورة تحول
في الطبيعة ولكن صيرورة اتّخاذ قبول شئ مزيد عليها (الجسد في نص الإنجيل، والحكم
باللعنة بحسب الرسول)، وإلى هنا لا إشكال، ولكن في نص أثناسيوس الكامل يفيد أنه لا
يخلط ولا يماهي بين نفي المعنى الخاطئ (الصيرورة جسداً) وبين نفي المعنى الصحيح
معه (قبول الجسد)، فهو يتكلّم عن "الجسد الذي كان الكلمة فيه" وعن
"الجسد الذي أتى الكلمة فيه" وهذه التعابير غابت عن نقل ثيودوريت للنص
الأثناسي، فمع سابق إطالة ثيودوريت في محاربة تعبير "الطبيعة الواحدة"،
فيكون الظاهر من كلامه أنه وإن اتفق مع أثناسيوس على رفض معنى استحالة الطبيعة
الإلهيّة، ولهما كل الشكر، فإنه يزيد فيماهي بين ذلك المعنى الخاطئ وبين رفض فكرة
اتحاد الطبائع فإنه ظن أن النص الأثناسيّ يدعمه، مع كونه بحس لغويّ دقيق إذ يرفض
معنى اتحاد الطبائع فإنه تجاهل حديث أثناسيوس الدالّ عن الكلمة "في"
الجسد"، وهنا لا اتهمه بسوء النية ولكن بسوء ضبط الفهم مع جودة
"ضبط" الاستشاد لدعم الفكرة الخاطئة لديه.. وبالمناسبة فإن تعبير البابا أثناسيوس
لا يخلو من مشاكل "عدم حرص" و"عدم تحسّب" لما قد ينبني على
تعبيرات تقبل تفاسير تشط لاحقاً وتقود لإثنينيّة مفرطة.. وإن كان لها مثائل
كتابيّة فإن النص اكلتابيّ يختلف عن النص الشارح، فالأول له سياقه الحامي له،
والثاني إذ ما أتى منفرداً في فقرةٍ ما فقد يفتح الباب للإضافة إلى قصده فيستلزم
إما استعمال بديل أدق منه أو الاعتناء بشرح حدود قصده.. تكرّرت مثل هذه الإشكاليّة
اللقظيّة كما يظهر في ملاحظات شروحيّة في الرسالة إلى إبكتيتوس
(الملاحظة "5-4" هي الأبرز في الدلالة مع تكرار الملاحظة في غير موضع)،
https://www.mediafire.com/file/20c4swdwxpfqntf/on2epictetus.txt/file وعالجها
البابا أثناسيوس نفسه فيما أسميه القانون الذهبيّ له: Athanasius,
Npnf, vol. 4, series II, De Synodis,
Pt. iii, parag.41, compare, Ibid, De Synodis, 21, 43,
44. Ibid, TOMUS AD ANTIOCHENOS, 8. Later
addition http://www.copticyouth4holybook.net/golden.jpg https://web.facebook.com/christopher.mark.5095/posts/10157737639744517?comment_id=10160834554804517 [v] بدأت
الأوراق المُتاحة بوقفة باسخاسينوس كليّ الوقار مندوب الكرسيّ الرسولي وسط كليِّ
الوقار زملائه وقال: "لقد تلقينا تعليمات على يد كليّ البركة الأسقف الرسوليّ
للمدينة الرومانية التي هي رأس كل الكنائس، وتقضي التعليمات بأن ديوسكورس (هكذا)
ليس مسموحاً له بالجلوس في المحفل، وإن حاول أن يأخذ كرسيّه ينبغي طرده.. وينبغي
تنفيذ هذه التعليمة وإلا خرجنا.. فأجاب
القضاة الاكثر مجداً وكل الشيوخ: ما التهمة التي تحملها ضد كليّ الوقار الأسقف
ديوسكورس؟ فقال
باسخاسينوس: "طالما أتى يجب منعه" فقال
القضاة: "بناء على قولك، قدِّم التهمة القائمة ضده" فاخذ
لوسينتيوس الكليّ الوقار مقعد الكرسيّ الرسوليّ وقال: "فليقدم سبباً لحكمه
على من لا يخضع لرئاسه، ولتجرئه على عقد مجمع بدون إذن الكرسيّ الرسوليّ، الأمر
الذي لم يحدث قبلاً ولا يمكن أن يحدث" ومن الطريف انهم يحاكمونه على ما لم
يحدث ولا يمكن أن يحدث رغم أنه حدث.. وفيما بعد يرد لقب أسقف روما ويقول المُحًقِق
أنه مكتوب "بابا روما" في النسخة اللاتينية بدلاً من أسقف روما".. Nicene and Post-Nicene Fathers,
2nd series, Vol XIV, pp. 247-248 edition by H.R. Percival, EXTRACTS FROM THE
ACTS. SESSION I. Paschasinus, the most
reverend bishop and legate of the Apostolic See, stood up in the midst with his
most reverend colleagues and said: We received directions at the hands of the
most blessed and apostolic bishop of the Roman city, which is the head of all
the churches, which directions say that Dioscorus is
not to be allowed a seat in this assembly, but that if he should attempt to
take his seat he is to be cast out. This instruction we must carry out; if now
your holiness so commands let him be expelled or else we leave. (1) The
most glorious judges and the full senate said: What special charge do you
prefer against the most reverend bishop Dioscorus? Paschasinus, the most
reverend bishop and legate of the Apostolic See, said: Since he has come, it is
necessary that objection be made to him. The
most glorious judges and the whole senate said: In accordance with what has
been said, let the charge under which he lies, be specifically made. Lucentius, the most
reverend bishop having the place of the Apostolic See, said: Let him give a
reason for his judgment. For he undertook to give sentence against one over
whom he had no jurisdiction. And he dared to hold a synod without the authority
of the Apostolic See, a thing which had never taken place nor can take place. وفي
الجلسة الرابعة عشرة يُسمعنا "القضاة كليّو المجد" دعوتهم لأساقفة بنتس
وأسيا كليِّي القداسة الذين وقعوا رسالة ليو بالإدلاء أنهم وقّعوها دون إكراه..
وعندما يتقدمون للوسط يقول الأسقف ديوجينوس أسقف سيزيسوم كليّ الوقار أنه وقَّع
بمحض تقدثره، ويتلوه بقيتهم.. ولكن عندما يأتي ذكر أساقفة قديسين لم يوقِّعوا فإن
لقبهم أنهم قديسون فقط دون مبالغة، وعند تعيين أحدهم، يوسابيوس أسقف أنسيرا
(انقرة) يرد اسمه دون أي لقب.. وفَّروا.. ولكن لماذا هذا؟ ثم تعود الدورة لذكر
القضاة الأكثر مجداً،،، وأخيراً يعلن لوسانتيوس الأسقف أن الكرسيّ الرسوليّ أصدر
هذه الاوامر ان كل شئ يتم في حضورهم (غير واضح حضور الكرسيّ الرسوليّ أم حضور
المجتمعين؟ وهناك قراءة ثانية لنفس الأمر في النسخة اللاتينيّة اكثر وضوحاً
واتساقاً تقول: "لا ينبغي إهانة الكرسيّ الرسوليّ في حضورنا" ومفهوم أن
عدم الإهانة ليس بالامتناع عن التعدِّي بل بالامتثال بالخضوع .. ويرد جون كليّ
الوقار أسقف سيباستي (سبسطيّة) فيقرِّر: "عن جميعنا سنبقى بالرأي الذي عبّرتم
عنه عظمتك" ولما انتهت أعمال المجمع بامتثال الجميع لرأي عظمته وجد القضاة
كليِّي المجد أن هذا القول أفضل ما يختمون ب الحاضرون كل كلامهم فقالوا:
"وافق المجمع المقدس على ما اقترحناه".. ويحبطني أنني لم أعرف من هم
القضاة كليّي المجد ولا ما اقترحوه ولا صفتهم في الاقتراح أصلاً.. Nicene and Post-Nicene Fathers,
2nd series, Vol XIV, pp. 294-295 edition by H.R. Percival, EXTRACTS FROM THE
ACTS. SESSION XVI. Lucentius, the
bishop, said: The Apostolio See gave orders that all
things should be done in our presence [This sentence reads in the Latin: The
Apostolic See ought not to be humiliated in our presence. I do not know why
Canon Bright in his notes on Canon XX VIII. has
followed this reading]; and therefore whatever yesterday was done to the
prejudice of the canons during our absence, we beseech your highness to command
to be rescinded. But if not, let our opposition be placed in the minutes, and
pray let us know clearly [Lat. that we may know] what we are to report to that
most apostolic bishop who is the ruler of the whole church, so that he may be
able to take action with regard to the indignity done to his See and to the
setting at naught of the canons. [John,
the most reverend bishop of Sebaste, said: We all
will remain of the opinion expressed by your magnificence.(1)] The
most glorious judges said: The whole synod has approved what we proposed. [vi] [After a
few remarks the reading was continued and the rest of the acts of the Latrocinium of Ephesus completed. The judges then
postponed to the morrow the setting forth a decree on the faith but intimated
that Dioscorus and his associates should suffer the
punishment to which they unjustly sentenced Flavian. This met with the
approval of all the bishops except those of Illyrica
who said: "We all have erred, let us all be pardoned." (col. 323.)] NPNF,
2nd series, Vol XIV, p. 248, edition by H.R. Percival, SESSION I.
[vii] الكنيسة
الارثوذكسيّة الشرقيّة هي اللقب الرسميّ للكنائس التي قبلت مجمع خالكيدونا وانفصلت
فيما بعد عن كنيسة روما بسبب بدعة انبثاق الروح القدس من الابن، فتلقَّبّت
بالشرقيّة بالنسبة لروما والكنائس الغربيّة التابعة لها: Easter Orthodox Church, EOC.، وفيما بعد وعندما ظهرت كنائسنا اللاخالكيدونا في صورة الحوارات
المسكونيّة، فللتميّز عن الـ EOC، اصطُلِح على تلقيب الكنائس الرافضة لمجمع خالكيدونا والمتبادلة
للحروم معه: Oriental
Orthodox Churhces..
ولكن الترجمة العربية لا تُفَرِّق، وكلنا في "الأرثوذكسيّة"
شرق.. |